4,763 عدد المشاهدات
الكاتب: د. علي عفيفي علي غازي – صحفي وأكاديمي مصري
منذ الانتكاسات التي مُنِيَت بها الأمة العربية، وانهيار شعارات الوحدة والقومية والمصير المشترك، مرَّ الإنسان العربي بحالة من الضياع والتشتُّت، وغياب الأهداف، ولم تعد هناك عواملُ مشتركةٌ غير اللغة، بغضّ النظر عن تعدُّد اللهجات؛ فالاختلافات في المذاهب الدينية، والسياسة، فضلاً عن التنوع الطائفي، اتُّخِذَت ذريعةً للتناحر، وتصفية الآخر، وتهميشه فكرياً وعقائدياً من قِبَل التيارات وليدة الإمبريالية الغربية، والتي قوَّضت الكثير من طموحات الشباب العربي، الذي اتُّهِم بسوء الفهم، والزندقة، والجهوية، والطائفية، أو صُبغ بالقومية، أو الوطنية، أو الدينية، أو المذهبية، دون النظر إلى أنَّ لهم آراءَ من حقهم التعبير والدفاع عنها.
تزداد الحاجة إلى التراث كي يُساعدنا على تصحيح ممارساتنا، ولكي نستقي منه ثقافتنا، ونستلهم منه القيم السليمة في سعينا لبناء الحاضر واستشراف المستقبل، لأنه يمثِّل العمود الفقري في التاريخ الحضاري والثقافي للأمة العربية والإسلامية([1])، في وقت تشتد فيه الحملة المعادية على الإسلام والمسلمين، بحيث صارت كلمة مسلم في أذهان الغربيين مرتبطة بكلمة الإرهابي عدو البشرية، وكاره الأديان الأخرى، والساعي إلى تدمير الحضارة، وإعادة العالم إلى الظلام، في ظلِّ غيابنا عن مقارعتهم بأدواتهم وأساليبهم نفسها، بما يوضح حقيقتنا وحقيقة ديننا الحنيف، والدور الحضاري الكبير الذي مارسه المسلمون عبر التاريخ، وكان من المُفترض أن نتخذ من المساحة الإعلامية عبر الإنترنت والتقنية الفضائية ووسائل الإعلام والاتصال الأخرى، مجالاً لتطوير خطابنا بما يخدم التراث وقضاياه.
لكن للأسف انفلت الخطاب الإعلامي الإسلامي المعاصر في بعض مناحيه عن العقلانية، وأهداف الوعي المنشود؛ ليُصبح وسيلة إساءة وأداة إضافية بيد أعداء الإسلام، في وقت أصبح فيه الاتصال عبر وسائل الإعلام شأناً مهماً في حياة الأفراد والمجتمعات. وتعدَّدت مفاهيم الإعلام ووسائله وأساليبه ومضامينه، وأخذت المعلومات تنتشر بسرعة هائلة إلى أغلبية سكان المعمورة، حتى إنَّ وصف الإعلام بأنه السلطة الرابعة، لم يعدْ تعبيراً عن درجة رابعة في التأثير في أنماط التفكير والسلوك الإنساني، بل تكاد هذه السلطة تتحكَّم في السلطات الثلاث الأخرى. وبنظرة سريعة لبعض مجريات الطرح الآني في الإعلام المعاصر، نجده لا يخلو من أفكار هجينة، والبناء على أرضية هشة، يؤدي بالبناء حتماً إلى الانهيار في النهاية.
معين لا ينضب
منذ مدة ليست بالقصيرة تداول الكتّاب والمفكرون في ميادين الأدب والفن والثقافة والإعلام ثنائية «التراث والمعاصرة» على أساس أنها ثنائية تضاد أو تقابل على أقل تقدير، وكأنهما لا يُمكن أن يجتمعا في غمد واحد، والسبب أنهم جعلوا التراث مرادفاً للأصالة، والمعاصرة مرادفاً للجِدة، واستقر في مفهومهم أنَّ أحد هذين المفهومين ينفي الآخر، أو لا يتحقَّق إلا على حساب الآخر، وهذا خلط يتطلَّب التأمل والمراجعة، فالتراث يُشكِّل حصيلة ما أنتجته عقول أبناء الأمم والشعوب من نتاج أدبي وفني وفكري، وهو بهذه الصورة معين ثري لا ينضب من الأفكار والمبدعات والأمثولات الدالة، التي تستند إليها الأمم في نهضتها العلمية والفكرية والثقافية([2]).
التراث، إذا أردنا الوقوف على مغزاه الحقيقي، حافز للنوابغ الموهوبين على استنباط مشاريع خاصة بهم، ينجزون فيها أبنية جديدة، من عناصر وأجزاء فيه متفرقة ومتباعدة([3])، وبالتالي يُشكِّل ينبوع الثقافة والأصالة، الذي يُغذي الوعي القومي والجمعي لدى الفرد والجماعة في المجتمع الواحد، أو في المحيط البيئي الذي تشترك فيه مجموعة من الشعوب. وهنا يتراءى لنا أنَّ العلاقة بين التراث والجِدة ليست، كما سبق الذكر، علاقة تضاد، وإنما علاقة تداخل وتخارج في آن واحد، تجعل كل مُبدع ضارباً بجذوره في التراث، ومُفترقاً عنه في نفس الوقت، بمعنى أنَّ الكاتب الأديب أو الفنان المبدع يحتفظ من التراث بأصالته، ويعمل في إطار معطيات هذا التراث، فينشأ جدل من خلاله بين عناصر التراث والواقع([4])، ألا وهو: هل نفهم التراث في ضوء الواقع، أم نفهم الواقع في ضوء التراث؟
الواقع والتراث
المثقفون في ذلك فريقان، منهم من يستنكر أي محاولة لرؤية التراث أو تفسيره في ضوء معطيات العصر، وحجتهم في ذلك أننا نُحمل الماضي أكثر مما يحتمل، ونضعه في أُطر من التصورات ليس لها أدنى تعلُّق بتصورات مَن أنجزوا ذلك التراث. آخرون يستنكرون الحكم على الواقع بمعطيات التراث، وحجتهم في ذلك أنَّ الزمن الحاضر غير الزمن الماضي، ومحال أن يكون أسلافنا قد تطلعوا بأبصارهم إلى هذا المدى من المستقبل، بحيث تستوعب نظرتهم واقعنا الذي نعيش فيه اليوم([5]).
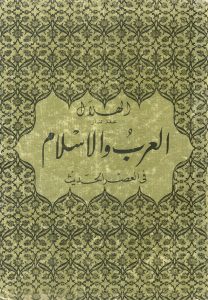
ولو أننا صدقنا الفريقين لكانت النتيجة أنَّ التراث والواقع متنافران، ليس بينهما أي تجاوب، لكننا سنجد من يغضب عندما يطرد الواقعُ التراثَ، وآخر سيغضب عندما يطرد التراثُ الواقعَ، وبالتالي نستمر في قضية تدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. فلو اقتصر الأمر على التراث على أن يكون له مجرد حضور في الذاكرة، لما كان له أدنى فاعلية، ولما تحقَّق التواصل بين حلقات التاريخ، وهذا أمر يختلف عن الوعي بالتراث؛ فقد يتذكَّر المرء أحداثاً كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يعي حدوثها؛ فوعي المرء لا يتقلص مع مرور الزمن؛ بل خلافاً للذاكرة ينمو في اطراد، ويرجع ذلك إلى طبيعته الجدلية.
احترام لا تقديس
يقول المفكر الكبير الدكتور زكي نجيب محمود: «هناك نقطتان: الأولى كنت أشعر في بداية حياتي العلمية أنني غير مُعبَّأ التعبئة الكافية بتراثنا؛ وذلك لأنَّ التربية في المدارس المدنية كانت تُعطينا هذا التراث قطعاً، ولا تعطينا إياه في صورة متماسكة، فخرجنا جميعاً وفكرتنا ضعيفة لا يعتمد عليها في هذا التراث العظيم…

فلما بلغت السن ما بلغت أحسست بمسؤوليتي نحو قلمي، ونحو عقلي وثقافتي، بألا أُصدرَ الأحكام الثقافية إلا وأنا مُلمٌّ بشيء يعتمد عليه في معرفة هذا التراث، لذلك انصرفت إليه بكل ما أستطيع من قوة لأعوض ما فاتني من نقص. وفي أثناء دراستي لهذا التراث كنت ألاحظ ملاحظاتٍ أَثْبَتُّها إمّا في ذاكرتي وإمّا في مذكراتي، إلى أن تكوَّنت لديَّ بعض الأفكار لا أدَّعي أنها صحيحة كلها، ولا أزعم أنها فاسدة، ولكنها على وجه العموم كوَّنت وقفة ووجهة نظر تتمثَّل في أنه لا بدَّ من تقديم هذا التراث لشبابنا على نحو يجعله جُزءاً من ثقافته، ولكن بشرط ألا يشعر الدارس أنه أمام شيء مقدس. النقطة الثانية، أننا عندما ندرس التراث ندرسه لا ليكون وحده هو الميدان الثقافي الذي نتحرَّك فيه دائماً ليكون جزءاً من كل، أمَّا بقية الكل فهي خاصة بثقافة هذا العصر الذي نعيشه، وأهم ما في هذه الثقافة التي نعيشها هو الجانب العلمي… فلا جدوى من أن نحبس أنفسنا بين جدران التراث، ولا جدوى من أن نتعصب للعصر وحده، وننسى شخصيتنا وتاريخنا، لذلك نتمنَّى أن نضمن الجزأين معاً لتتكوَّن لنا صيغة موحدة لثقافة نستطيع أن نعيشها»([6]).
الثابت والمتغيّر
لقد تمَّت محاولات لفهم التراث، وتصنيفه في ضوء فكرة الثابت والمتغير([7])، إلا أنَّ التراث في وعينا لا يُمكن أن يكون ثابتاً، بحكم طبيعة الوعي الجدلية، ومن ثمَّ فالتراث يتمثَّل في ثلاثة مستويات، هي السكونية والحركية والتغيرية، والمعول الأول والأخير فيما يلحق بالتراث من هذه الصفات الثلاث يتوقَّف على موقعنا من هذا التراث، وعلى أسلوب تعاطينا معه، هل نحفظه كي نُحافظ عليه، أم نختزنه، سواء كان هذا الاختزان في ذاكرة الإنسان، أو في المخطوطات والكتب، أو النقوش الأثرية، أو منقوشاً على صفحة الذاكرة، فنُضفي عليه بذلك صفة السكونية، أم نعيه من واقع تجاربنا، ومن منظور اللحظة، بمعنى أن ننقله من حالة الحفظ إلى الحالة التي يصير فيها موضوعاً للوعي، فالوعي بأي جزء من المادة يعني أنَّ هذا الجزء قد صار حياً متحركاً، فنُسبغ عليه صفة الحركية، ونُحقق له بذلك الوعي والقدرة على التناسل والتجدُّد والتغيُّر.
وعلى هذا قد تكون المادة التراثية ثابتة ومتحركة في آن واحد، فما يُحفظ منها في الذاكرة والكتب المدوّنة يُمثل الساكن، وما نعيه منه يُمثل المتحرك، وما هو ساكن في ذاكرة إنسان قد يكون متحركاً في وعي إنسان آخر، ومن هنا يأتي الاختلاف الجوهري في مواقفنا نحن المتعاصرين من التراث، فمنا من يحفظه، ومنا من يعيه، فيعرِّفه بأنه مجموعة من التصورات الدائمة الحركة والتوالد، ويُفضي هذا التناسل بالضرورة إلى المُغايرة، وربما نقضها، فلا أحد يستطيع التنبؤ مطلقاً بنتيجة الجدل الذي يتمّ في الوعي بين المادة التراثية والواقع المعيش، فالتراث يتناسل في هذا الواقع المتجدد والمتغير من خلال الوعي البشري به في أشكال مغايرة تبلغ أحياناً حداً تكون فيه مناقضة للأصل التراثي الذي تعود بجذورها إليه.
الإدراك الواعي للتراث
والشخص قد ينبغ في مجال نشاط بعينه، كالشعر مثلاً، مؤكداً بذلك تفرده، لكن هذا النبوغ لا يتحقق إلا من خلال الإدراك الواعي للتراث في مغزاه وموقعه بالنسبة إلى الواقع الراهن، ولما كان هذا الواقع مُتجدداً ومُتغيراً، كان بمقدورنا الإجابة عن السؤال الخاص بالتراث من حيث حده الزمني. إنَّ السؤال عن تراث أمة ما متى بدأ يُعدُّ سؤالاً إشكالياً لا يُمكن حسم الإجابة عنه، ذلك أنَّ أسلافنا يمتدون إلى آبائنا وأجدادنا، وعلى هذا الأساس يُصبح التراث مُمتداً فيناً، لنُصبح في يوم ما تراثاً لأبنائنا وأحفادنا، وبهذا المعنى يُصبح التراث ممتداً في الزمن بلا نهاية، ومتجدداً ومتغيراً([8]).
يقول مؤرخ الأدب العربي الدكتور شوقي ضيف: «إنَّ التشكيك في قيمة التراث لا أساس له من الصحة؛ لأنَّ أمم التكنولوجيا الحديثة تعتني بتراثها لسبب طبيعي، هو أنَّ التراث يحمل ماضي الأمة، وقيمها الروحية والخلقية والاجتماعية والفكرية، بينما التكنولوجيا تعنى بالحياة المادية، ولا تضارب بين هذا الجانب والجانب السابق، بل إننا نجد أمم التكنولوجيا الغربية لا تكتفي بالعناية بتراثها الخاص، فهي تعنى أيضاً بالتراث العربي، لأنه عنصر مُهم متداخل في حضارة الإنسانية، فإن حضارتهم الحديثة استُمدت من الحضارة القديمة بما يشمل الحضارة العربية، ولا تكاد توجد جامعة كبرى في الغرب إلا وتدرس التراث العربي، فنحن أولى بدراسته والعناية به؛ لأنه يحمل تاريخنا ومقوماتنا وشخصيتنا، وفيه تخلّقت قوميتنا، وتخلَّق وجودنا وكياننا كله»([9]).

ضرورة الانفتاح
ووعي المرء بتراثه الخاص لا ينفي إمكانية وعيه بالتراث الآخر، الذي تملكه الشعوب الأخرى، فعلى الرغم مما يتمتّع به التراث من الثراء، هناك دائماً ما يدعو إلى الخوف من أنَّ الاستغراق فيه قد يُفضي إلى تسلل الضعف إلى النسل الجديد جيلاً بعد جيلٍ، فالتراث القومي لإنسان ما خليق بأن يقوى في وعيه عندما يقترن بتراث أمة أو أمم أخرى، وبهذا المعنى يُصبح الانفتاح على الآخر دعماً للتراث الخاص، وليس كما يتصور بعض الناس تهديداً. إنَّ وعي الأديب أو الفنان للتراث هو تجربة كل منهما على حدة، وهو غير مُنفصل عن وعيه بالتاريخ في ماضيه وحاضره ومستقبله، ومن خلال هذا الوعي المتآزر، يتحقَّق الأديب والفنان، وتتحقَّق للأدب والفن صيرورتهما، ويتحقَّق للمتلقين النماء والثراء.
التراث العربي الإسلامي دونه أفراد من مختلف أصقاع العالم من بخارى وسمرقند وفارس والأندلس وبغداد والقيروان ودمشق والقاهرة، وجمعوا عصارة فكرهم ونتاج عبقريتهم على الورق، وشاءت الظروف أن تنتقل تلك الأوراق والمخطوطات في رحلة العلم الطويلة إلى أماكن أخرى وتتكدَّس فيها وتتجمَّع، مثل أوروبا وأمريكا وبلاد أخرى([10])، فالعلم لا وطن له. لقد أعطى أسلافنا وقدموا للبشرية إنتاجاً علمياً لا يُقدر بثمن، من دون أن ينتظروا المكاسب والأرباح المادية. لقد أدرك أجدادنا أنَّ العلوم ليست مقصورة على حضارة دون سواها أو شعب دون آخر أو أمة دون أخرى([11]). ويعكس هذا بجلاء ضرورة الاهتمام بالتراث باعتباره «شاطئ الأمان وطوق النجاة في طوفان العولمة، ذلك الشبح القادم لمسخ الهوية القومية»([12]).
الوفاء للتراث
إحياء التراث وتحقيقه ضرورة علمية قوميّة حضارية إنسانيّة، كما أنه ضرورة لكلّ أُمةٍ تُقدِّر ما هو قيِّم، وتحاول أن تُفيد منه في الحاضر والمستقبل([13]). إنَّ الاهتمام به «ليس تاريخياً ماضوياً بقدر ما هو عمل حياتي مستقبليّ، والأمر لا يُمكن أن يبقى، كما هو الآن، في حدود الوفاء النظري له والإشادة العاطفيّة به، وإنما هو كذلك، أو قبل ذلك، في الانتفاع به، والوفاء لأنفسنا من خلاله، إنه ليس زينة، ولكنه سلاح، وليس تباهياً وإدلالاً، ولكنه قبل ذلك نوع من الإعداد، ولون من كسب الثقة بالنفس»([14]).
يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «إحياء التراث العربي لا بدَّ له من عملين متلازمين يتوقَّف أحدهما على الآخر. أحدهما نشر الكتب والآثار العربية في جميع الأقطار التي تقرأ لغة العرب.

والثاني إيجاد الرغبة في قراءة هذه الكتب والإحاطة بهذه الآثار، أو تنشيط هذه الرغبة إذا كانت موجودة على حالة من الضعف والفتور، إذ لا يكفي نشر الكتب والآثار لإحياء التراث العربي، إذا نحن نشرناها بين أناس لا يراعونها، ولا يُقبلون عليها، ولا يشعرون بالحاجة إلى دراستها والإلمام بها. وكثيراً ما تكون طريقة النشر سبباً من أسباب الترغيب في القراءة والتنشيط إليها، وكثيراً ما تكون الرغبة في القراءة والنشاط إليها سبباً من أسباب العناية بالنشر والتوافر على وسائله المثلى. ومن ثمَّ نقول: إنَّ إحياء التراث العربي يحتاج إلى عملين متلازمين، وإنَّ كل عمل من هذين العملين يتوقَّف على الآخر. وعندنا إن الوسيلة المثلى لإيجاد الرغبة في إحياء التراث العربي هي مزجه بالحياة الحاضرة، وتحويله إلى مجراها، فلا يُشارفه الإنسان كما يُشارف متحفاً قديماً للآثار المحفوظة، بل يُشارفه كما يدخل في معترك الحياة، وينغمس في تيار الشعور والعاطفة، وليس ذلك بعسير إذا حسنت المطالعة، وحسن الاختيار، وحسن التنبيه»([15]).
إذاً الحلُّ يأتي من التوفيق بين التراث والحداثة، بحيث نُبقي على التراث ونُهيئ الفرصة للحداثة، فلا نتعصَّب للتراث لأنه تراث، ولا نقف في وجه المعاصرة لأنها معاصرة، ويتأتى ذلك من خلال تعميق الانتماء إلى القيم والأعراف والتقاليد والتراث والفكر العربي، بالحفاظ عليه وغرسه في جُرعات مكثفة ومستمرة في عقل ووجدان الشباب العربي. ولا ننسى أنَّ نشر التراث العربي والإسلامي يُفيد في معرفة تاريخ العلماء الذين مهدوا الطريق لنا، وسلكوا ضروباً مُضيئة، واحتملوا عناءً باهظاً، وأظهرونا على مداخل هذا التراث، ويمثل تاريخ العلم وفلسفته، والمراحل والتطورات التي مرت بها المسيرة العلمية في العصور الوسطى، وعن طريقه يُمكن قراءة كل الإنتاج العلمي القديم، إذ إنه عالمي بمصادره ومنابعه وتطوراته، وامتداداته، والتقاء الحضارات معروف مشهور، والتأثير والتأثر بين الشعوب حتمي ولازم، والحضارة العربية واحدة من الحضارات الإنسانية الشامخة، وهي حضارة عريقة ممتدة الجذور، جلّاها وكشفها ونمّاها الإسلام، ثمَّ امتدت فتوحاته ودخلت فيه أمم أخرى كثيرة ذات حضارات قديمة، هجرت تلك الأمم لسانها القديم، واتخذت اللسان العربي أداة فكر وبيان، فالعلماء الذين كانوا يكتبون بلغتهم الأم كانوا يقومون بنقل مؤلفاتهم إلى العربية، التي أصبحت لغة العلم بدءاً من القرن التاسع الميلادي، وأخذت بُعداً كونياً، فلم تعد لغة التعبير عند العرب وحدهم، بل لعدة شعوب، ولغة لكل المعارف، وبالتالي التراث. لقد استقى أسلافنا العلم من الهند والصين إلى اليونان، وأضافوه إلى إرث اليمن ومصر والعراق، وترجموا وطوروا واخترعوا، بحيث أضحى علمهم علم العالم، ولغتهم لغة العالم على امتداد سبعة قرون([16]).
معاداة التراث
في البدايات انبرى بعضهم بتأثير دوافع أيديولوجية ضيقة، وبقصر نظر تاريخي محض، لمهاجمة التراث العربي الإسلامي، بأنه إزجاء للوقت، وبأن هذه الأعمال التراثية تصلح لعرضها في المتاحف فقط، أو من باب الترف الفكري، وحاول بعضهم الآخر أن يلتزم الحياد بموقف توفيقي، مطالبين بأن يؤخذ من التراث الأشياء الجيدة المفيدة، وينبذ ما عدا ذلك، بحسب المعايير المعاصرة والأحكام المسبقة، وعلى هذا الأساس ما إن هلَّ منتصف القرن التاسع عشر حتى بدأت طلائع حركة لجمع التراث مدفوعة بدوافع ذاتية تركَّزت في جمع النصوص وتفسيرها لُغوياً دون التوقف لدراستها، ومع تقدم خمسينيات القرن العشرين بدأت هذه الدراسات تأخذ شكلاً مختلفاً وجاداً، وتدخل الجامعات العربية فيما يُمكن أن نُسميه الاهتمام الأكاديمي، وتشهد الساحة الثقافية في الوقت الحاضر نهضة تراثية علمية، تتمثل في الإقبال على تحقيق ونشر كتب التراث باعتبارها ضرورة علمية([17])، كما تتمتع بنسبة معقولة من القرّاء، بعد أن ظلَّ التراث العلمي العربي الإسلامي المخطوط محفوظاً في خزائن الكتب، وفي بطون المجلدات والأوراق على حالته كما تركه أصحابه، رغم ذلك لا يزال ميدان الاهتمام بالمخطوطات العربية وتحقيقها لا يغري سوى فئة قليلة من الدارسين والباحثين.
ومع الحركة الثقافية النشطة التي شهدتها دول الخليج في الربع الأخير من القرن العشرين، وضمن محاولة جادة ومهمة ومباركة من قيادات تلك الدول، وبإسهام ملحوظ في توفير الإمكانات اللازمة، نشأت مجموعة من مراكز الوثائق والدراسات تنهض بمهمة عظيمة وجليلة في جمع الوثائق، وجمع التراث، وحشد بنية أساسية ضخمة لكل ما يتعلق بهذا المجال، وانطلقت من خلالها كتائب الباحثين لجمع الوثائق، وتسجيل الحكايات من أفواه كبار السنّ، وكل ما حفظته السنون. ومن خلال الأمانة العامة لهذه المراكز، وعبر خطة للتعاون الأخوي بين الأشقاء، أخذت الوثائق والموروثات تنتقل من مركز لآخر في حركة نشطة للتبادل والتعاون توفيراً للجهد والمال، ولا تزال حركة الجمع متواصلة ومستمرة بصورة مُرضية.

دور مراكز الدراسات
وفي سبيل جمع التراث والتاريخ وتوثيقه ودراسته، والأخذ بالجوانب المضيئة فيه، واستثماره، قامت في دولة الإمارات العربية المتحدة، كنموذج، مراكز ومؤسسات ولجان وجمعيات رسمية وأهلية، تفرَّغت لأعمال تدوين التراث وجمعه وإحياء ما اندثر منه، وعلى صعيد المراكز والمؤسسات الرسمية يبرز دور مركز الوثائق والدراسات المنبثق عن المجمع الثقافي في أبوظبي، ومركز زايد للتراث والتاريخ بالعين، وهناك أيضاً مراكزُ ولجانٌ مماثلة تابعة لدواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. وعلى الصعيد الأهلي يبرز دور جمعيات الفنون الشعبية والتجديف المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارات، وجمعية إحياء التراث الشعبي، وجمعية النخيل للفنون الشعبية برأس الخيمة، فضلاً عن الجهود والاهتمامات التطوعية الفردية من دراسات وبحوث وجمع للتراث والوثائق، والتحقيقات الميدانية، إضافة إلى بعض الاهتمامات الفردية في مجال اقتناء وحفظ المواد التراثية المادية، كالتُحف والقطع الأثرية التراثية المختلفة([18]).
إنَّ الإشكالية الحقيقية تتعلَّق بجملة قضايا متفرعة أبرزها: مفهوم التراث العربي والموضوعات والحقول المعرفية التي يُغطيها ويتعرض لها، والمنهجية العلمية الصحيحة في البحث التراثي، أو التوازن الدقيق بين باحث يحيا في الألفية الثالثة، ومعها العولمة، ويحاول التبحر في فكر مجموعة من الأفراد عاشوا في أوقات بعيدة مختلفة، وكشف علومهم وأفكارهم بموضوعية وحياد.
فالأمر يتطلَّب وعياً تراثياً حقيقياً تراكمياً، يؤهل للتعامل الصحيح مع التراث وقضاياه المتشعبة، والذي من دونه سوف تذوب الأجيال القادمة في محيط العولمة بلا هوية ولا حضارة ولا طاقة على تحديد مسارها أو اختيار مصيرها. فالتراث العربي يُمكن أن يُسهم إلى حد كبير في حوار الحضارات بين الشرق والغرب، ويلعب دوراً في تقريب وجهات النظر المختلفة، والمتنافرة([19])، فهو ثمرة احتكاك وتلاقح ثقافات وحضارات عدة استطاع أجدادنا ببراعة صياغتها وإغناءها؛ فأصبحت نسيجاً متفرداً ليس مقطوع الجذور؛ بل تراثاً حضارياً مهماً ومتشعباً لا يُستغنى عنه في مسيرة الحضارة البشرية عبر التاريخ، باعتراف مؤرخي العلوم من المستشرقين، فيقول نيكلسون: «وما المُكتشفات اليوم لتحسب شيئاً مذكوراً إزاء ما نحن مدينون به للروّاد العرب الذين كانوا مشعلاً وضّاءً في القرون الوسطى المُظلمة في أوروبا»([20]).

وختاماً، لا مناص من تعرُّف حضارة الأمة العربية والفكر الإسلامي من جميع جوانبه؛ وإحياء ما خلفته هذه الحضارة من أعمال فكرية، ونشر المخطوطات القديمة، ولا نترك المجال للمستشرقين، لأن بعضهم ممن تصدوا لتحقيق بعض كتب التراث كانوا غير محايدين، وغيّروا في بعض النصوص كي تأتي متفقة مع ما يُريدون أن يُشيعوه، وكذلك للدفاع عن العرب، وبيان سبقهم في كثير من العلوم، فكثير من النظريات والأفكار التي يدّعي الغربيون أنَّ الفضل في وجودها يرجع إليهم، إنما نبتت عند المسلمين، وأخذها الغرب عنهم، كما أنَّ الاهتمام بالتراث سيعمل على إحياء اللغة العربية؛ لأنها لغة التراث، وإحياؤنا للتراث إحياء لها.
المراجع
([1]) محمد عبد القادر: «إحياء التراث ونشره دعم للحاضر واستشراف للمستقبل»، مجلة الوثيقة، العدد 21 (يوليو 1992)، ص90-92.
([2]) علي إبراهيم النملة: «أثر المستشرقين في خدمة التراث العربي الإسلامي»، في كتاب ندوة الطباعة حتى انتهاء القرن التاسع عشر، (أبوظبي: منشورات المجمع الثقافي، 1996)، ص309.
([3]) زكي نجيب محمود: «إحياء التراث وكيف أفهمه»، مجلة العربي، العدد 265 (ديسمبر 1980)، ص12-13.
([4]) جابر عصفور: «استلهام التراث الأدبي»، مجلة تراث، العدد 136 (يناير 2011)، ص26.
([5]) محمد عدنان سالم: «التراث في تجربة ناشر عربي»، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 8 (مارس 1995)، ص52.
([6]) «التراث العربي وكبار المفكرين»، الأقارب، جريدة عربية شهرية تصدر من بومباي، 18/11/1986، ص13.
([7]) سعيد يقطين: «دوائر التراث ومساراته» مجلة تراث، العدد 160 (فبراير 2013)، ص20-21.
([8]) حسام دبس وزيت: «التراث والحداثة في الفكر المعماري العربي المعاصر»، مجلة التراث العربي، العدد 112 (ديسمبر 2008)، ص153.
([9]) «التراث العربي وكبار المفكرين»، الأقارب، جريدة عربية شهرية تصدر من بومباي، 18/11/1986، ص13.
([10]) عبد الجبار عبد الرحمن: «تسريب التراث العربي المخطوط إلى المكتبات الأوروبية والأمريكية»، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 31 (أكتوبر 2000)، ص50.
([11]) شكري فيصل: «التراث العربي خطة ومنهج»، مجلة التراث العربي، العدد 3 (أكتوبر 1980)، ص211-212.
([12]) عبد الله بن خالد آل خليفة: «التراث الشعبي طوق النجاة في طوفان العولمة»، مجلة الوثيقة، العدد 38 (يوليو 2000)، ص8-9.
([13]) مصطفى محمد طه: «العودة إلى التراث ضرورة حضارية»، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 70 (يونيو 2010)، ص38-39.
([14]) شكري فيصل: مرجع سابق، ص212.
([15]) عباس محمود العقاد: «التراث العربي ووسائل إحيائه في هذا العصر»، في كتاب العرب والإسلام في العصر الحديث، (القاهرة: دار الهلال، د. ت.)، ص93.
([16]) رياض نعسان أغا: «لماذا ندرس التراث؟»، مجلة تراث، العدد 157 (نوفمبر 2012)، ص146.
([17]) عبد الرزاق حسين: «تحقيق المخطوطات ضرورة علمية»، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 77 (مارس 2012)، ص126-127.
([18]) جمعية النخيل للفنون الشعبية: لمحات عن تراث وفلكلور مجتمع الإمارات، (أبوظبي: منشورات المجمع الثقافي، 1996)، ص15-17.
([19]) مصطفى محمد طه: «حوار الحضارات: الحضارة الإسلامية نموذجاً»، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 37 (أبريل 2002)، ص15-16.
([20]) محمود محمد الطناحي: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1984)، ص16.





