3,726 عدد المشاهدات
مدارات ونقوش- محمد التداوي
كانت الصحراء بالنسبة إليَّ عالماً مجهولاً مهيباً في العقدين الأولين من حياتي، كنت لا أهابها فحسب، بل كنت أخافها، ومجرد ذكرها كان يُحْدِثُ لي قلقاً تطور في مرات قليلة إلى رعب، خاصة إن تبع ذلك الذكر زيارة إلى الجبل، كما كان يسميها أهل غرب الدلتا تحديداً، وبالتالي النوم هناك؛ فلا مجال للعودة إلا بعد واجب الضيافة، وذلك يعني المبيت على أقل تقدير.
وعلى الرغم من قربي المكاني الشديد من الصحراء، التي هي جل أرض مصر والعرب، فإني كنت بعيداً جداً عنها حسياً، ولدت عند الحد الفاصل بينها وبين أرض الدلتا السمراء جداً قرب فرع رشيد، والتي يتدرج لون أرضها المكسوة بسمار الطمي، متدرجة بذلك السمار باتجاه اللون الأصفر كلما اتجهت غرباً أو كلما صادفت تلة أو كوماً، كما يسميها أهل البلاد.
ربما البداية لا تبشّر بخير عن الصحراء وعالمها، ربما أنت أيضاً لا تزال تتحاشاها وإن كان الفضول يثير الرغبة في العصر الحديث لعمل رحلة سفاري بكل إمكانيات الرفاهية الحديثة، لكني أؤكد لك أنه عالم آخر غير الذي سمعت دائماً عنه. أنا الذي كنت أسمع اسمها فأفتعل الأعذار كي لا أذهب مع أبي في زيارة لأقارب لنا يسكنون الصحراء في غرب الدلتا، في مناطق مثل حوش عيسى وأبوالمطامير، ومن بعدهما من القرى المستصلحة التي اشتهرت باسم القرى الجديدة، وما أكثرها مثل نجيب محفوظ والإمام الحسين والشعراوي والنجاح والكفاح وقبلها بدر.
لا أعرف تحديداً ما الذي جعلني أتخذ القرار بأن أقتحمَ ذلك المجهول، وهو كان كذلك بالفعل، إلا من روايات جلها أسطورية عن عالم الصحراء، والواحات والثانية تلك هي التي شجعتني أكثر على ذلك الاقتحام، كي أستكشف بنفسي صحة ما هو معروف ومتداول عن ذلك المجهول. وكانت أبعد الواحات عن نهر النيل ودلتاه هي المحفز الأكبر بسبب كمِّ المعلومات والكتابات التي جمعتها عن الواحات وتاريخها، وربما ما كتب عنها باللغات غير العربية يفوق ما كتب عنها بلغة أهلها بأضعاف مضاعفة جعل فضولي يتزايد يوماً بعد يوم، وهو الفضول الذي أعطاني واحدة من أقوى جرعات الشجاعة في حياتي لأقوم بتلك الرحلة وحدي إلى سيوة.
أربعون يوماً من الساحل عند مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث الرمال البيضاء والشواطئ الممتدة. تحركت بعدما أن سحرت عيني بمنظر المياه، متجهزة لصومها عن رؤية أي لون غير الأصفر لمسافة 350 كيلومتراً باتجاه الجنوب، حيث واحة سيوة.
وحده اللون في الأفق الذي يعرضه زجاج السيارة الأمامي، أصبح كشاشة عرض سينمائي، تخرج أمامي كل المشاهد التي تخيلتها لكل شخوصي الذين تعاملت معهم حين بدأت رحلتي البحثية في تاريخ الصحراء المصرية، خاصة سيوة وما سطرته كتب التاريخ عنها.
في الفترة الأخيرة عرض مسلسل كتب قصته الروائي الكبير بهاء طاهر، وكانت سيوة مسرح روايته الرئيس، وبطلها كان ضابطاً مصرياً عمل مأموراً للشرطة في واحة سيوة في نهايات القرن التاسع عشر، وشهرته في التاريخ سلبية جداً، حيث إنه من قام بتفجير معبد مهم، هو معبد أم عبيدة الذي يعود إلى نهاية الأسر المصرية، حيث شيده الملك نختانبو الثاني، من أجل بناء مركز للشرطة بالحجر بدلاً من القديم المبني بمادة الخورشيف أو الكورشيف، وهو خليط طبيعي من الملح وتربة السبخات التي تحجرت بانحسار المياه عنها وشكَّلت كتلاً شبه حجرية استخدمها سكان الواحة كمادة أساسية للبناء، وساعدهم جفاف المناخ على صمودها، حيث إنها هشة جداً إذا تعرضت للمياه التي تذيب ملحها بسهول تؤدي إلى الانهيار، وبالتالي التهدُّم، وهو الذي حدث مرات قليلة في تاريخها.
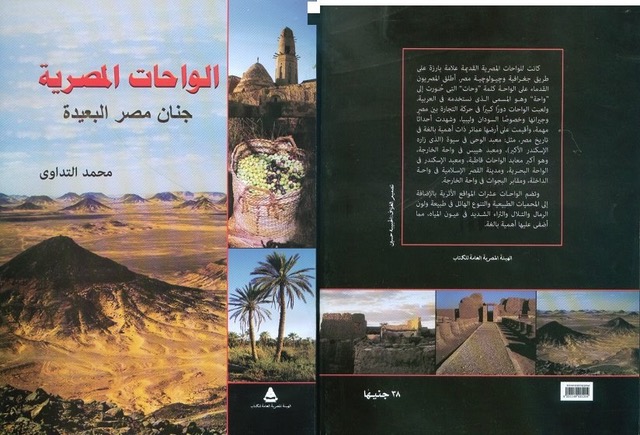
أحاول أن أخرج نفسي من ذلك التخيل، فتوقّفت مجبراً لا لزحمة السيارات المنعدمة تماماً، حيث لم تقابلني بعد أول ثلاثين كيلومتراً أية مركبة، غير قطيع من ستة عشر جملاً بدأت في عبور الطريق، نظرت حولي أبحث عن صاحب، عن راعٍ، عن أي أحد يحرسها أو يتابعها فلم أجد، حينما عبرت لم تذهب بعيداً وتجمَّعت حول منطقة اعتقدت في البداية أنها منطقة عشبية، فإذا بها تجمّع لمياه الأمطار التي هطلت على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط في تلك الفترة، فأنا اتخذت حذري في ألا أذهب صيفاً.
لم أكن مجبراً بوقت محدَّد مثل الإسكندر المقدوني، وقت يحدده كل حاجة في الصحراء، يحدده كمية ما تملك من طعام، من ماء، من وقود، من صبر، من خبرة بطرقها، ودروبها، فلا ننسى كم نحن محظوظون بامتلاك تكنولوجيات تحدد أماكننا واتجاهاتنا، بل وهواتف تقرب البعيد وتنقذ المعزول.
الإسكندر حينما تاه في طريقه باتجاه واحة سيوة، التي أسماها مؤرخو اليونان «جوبتر آمون»، وهو تزاوج بين إله اليونان جوبتر وإله المصريين الرئيس آمون رع، من أجل ذلك السؤال الذي حيره دائماً في مسألة نسبه هل هو ابن فيليب فعلاً؟ أم إنَّ اتهام المقدونيين لأمه صحيح؟ ففاجأه خداع الكهنة المصريين بجواب أرضاه بنسبه لأمون جوبتر كعادة الملوك المصريين، وتوج كفرعون مصري بالتاجين الأحمر تاج الدلتا، والأبيض تاج الصعيد، والذي جمعهما الملك المصري نعرمر الملقب بمينا في العام 3200 تقريباً قبل الميلاد. نسب فرح به كثيراً ذلك المحارب الشاب الذي خلدته سرعة انتصاراته العسكرية، وحنكة من كهان يسكنون واحة بعيدة خافوا على هدم معبدهم وزوال إلههم فزيَّنوا له بخداعهم ما تمنّاه وما لم يتمنَّه، وشيدت باسمه المعابد في كل مصر، وإن كان ما تبقى منها قليلاً كالوقت الذي قضاه على أرض مصر قبل أن يتركها باتجاه الشرق مستكملاً غزواته.
اشتهر الإسكندر في التاريخ بسبب تقارب أو تشابه بين قصته وربما بين مظهره وبين القصة الشهيرة لذي القرنين في القرآن الكريم، وفي قصة اتجاهه للغرب أنه بلغ موضعاً فيه عين حمئة.
»حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْماً قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً «سورة الكهف الآية 86.

فتشت ذاكرتي فيما كتب عن العيون والآبار في منطقة الصحراء الغربية من مصر، فوجدت في أحد التقارير الجغرافية عيناً طبيعية في منطقة تتبع سيوة، وهي على مسافة تزيد على مائة كيلومتر يسار الطريق باتجاه الجنوب عند منتصف الطريق تقريباً بين مدينة مرسى مطروح وواحة سيوة. السؤال الذي يدور بذهني وقتها هل أذهب إلى العين؟ وهي التي تقع في واحة صغيرة اسمها قارة أم الصغير أو جارة أم الصغير بحسب منطوق القاف، والقارة هو مسمى جغرافي صحراوي للمناطق الواحية التي يتوافر فيها قليل من ماء يساعد على البقاء مع انخفاض لمستوى سطح الأرض.

لم أزل في بداية الرحلة التي لم أكن أعلم وقتها بتاريخ النهاية، والذي ما زلت لا أعلمه لقراري باستمرار الرحلة مدى حياتي ولو تقطعت رحلاتي إليها لأسباب حياتية أخرى، فأنا أعود إليها كمحب في المقام الأول بعدما كنت كارهاً من المقام القريب. توقفت بالسيارة عند المنطقة المسماة ببير النص، والتقطت بعض صور لأعشاب نمت على جانب الطريق تعرّفت من بينها إلى الرطريط، وهو نبات صحراوي معروف.
أكملت طريقي باتجاه العين الحمئة في طريق ليس به محطات للوقود، وإن كان في بعض مناطقه هو مصدر الوقود ذاته، حيث تتوزع شركات التنقيب والتعدين غربي وشرقي الطريق، كنت قد اتخذت حذري بتمويل السيارة كاملة، وإضافة عبوتين كبيرتين في حقيبة السيارة الخلفية معزولة عن بعض مؤن سأحتاجها. حين اقتربت من أم الصغير يبدأ الطريق بالانحدار إلى مستوى منخفض، حيث أطراف منخفض القطارة الشهير.
أصبح لكل مكان مكان خاص في ذاكرتي يبدأ في عرض أسماء لحكايات تتعلَّق بالمكان المذكور، وعن منخفض القطارة حكايات وروايات لا تنتهي، ربما للحرب العالمية الثانية الذكرى الأشهر، وحكايات الحرب كثيرة، ما بين قصص فردية شخصية لجنود شحنوا من بلادهم البعيدة، باردة كانت أو حارة، إلى عنق الزجاجة الرابط بين منخفض القارة ومدينة العلمين على الساحل الشمالي، ليستكملوا مشاهد حرب لا زالت آثارها السلبية حتى الآن في ساكني الصحراء بسبب ما خلفوه من ملايين الألغام الفردية.
أستفيق من استرجاعي لبعض حكايات لا يتسع مقالي لذكرها، على أغنية لواحد من مطربي الصحراء الغربية في مصر، وهو شهير بينهم توفي منذ أعوام قليلة وقت زيارتي الأولى، اسمه خميس المجعاوي، ومن لا يعرف التنوع الكبير في الثقافة المصرية والتراث المصري ينكر على المهمشين فنهم، وبالتالي لا يعرف أبناء المدينة منهم أحداً، وخميس المجعاوي ومعه عوض المالكي، وصديق بوعبعاب وآخرون مشهورون أكثر في ليبيا رغم مصريتهم.
«ناريت اليوم غزيل» كما ينطقها، أو أنا رأيت اليوم غزيل كما تعني، واسم الأغنية حفزني لأبحث بعيني في الأفق علِّي أرى قطيعاً من الغزلان، وهي التي كانت تجوب الصحراء في فترات كبيرة من تاريخ الصحراء وإن كان أشهرها غزال دوركاس المصري. فلم أرَ غير بعض خرفان وجديان تتقافز أمام المدرسة الابتدائية التي تستقبل الوافدين إلى الواحة، يتلوها بيوت لا تشبهها في شيء اللهم إلا بعض التجارب لإنارة البيوت بالطاقة الشمسية، وهو مشروع غيَّر كثيراً في مستوى الواحة، والتي ما زالت حتى الآن تتبع الماضي إلا من تغيير الملابس وانتشار بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة أطراف التكنولوجيا من تلفاز وخلافه.
خلف تلك البيوت المتوزعة، والتي لا تتجاوز الطابق إلا في حالات نادرة، تقع القلعة القديمة نصفها الظاهر يعطي فكرة عن الدمار الذي حلَّ بها منذ أن اقتنع الأهالي بتركها في ثمانينيات القرن الماضي، ومن الجهة الأخرى عمليات الترميم التي أظهرت تقدماً واضحاً في استعادة نظم بناء لم يعد مستخدماً في أي مكان خاصة مواد بنائه البيئية. إلى يسار المدخل يقبع مقام أحد أولياء الواحة وهو سيدي ياجى، وله أيضاً قصة ربما كان لها دور في مقال قادم مثل مواضيع أخرى عديدة.
الحقيقة استقبلني أهل الواحة استقبالاً حملني بفضول أكبر، كيف لأناس بهذا العوز يقدمون لضيفهم ما يستطيعون، وربما كان أفضل ما يملكون من طعام، أكلت معهم وتعرَّفت بعض قصص بدؤوا وحدهم في سردها أمامي، ومنها قصة خط الهاتف الذي كان يصل الواحة بسيوة من ناحية والقطر المصري من ناحية في منتصف القرن الماضي، وكيف أنه أهمل بعد ذلك حتى انقطعت الواحة عن العالم من جديد، وأصر أحد أحفاد أحد عمال صيانة ذلك الخط على عرض ميراثه من جده فيما يخصُّ هاتفاً قديماً وبعض أسلاك، وأرشيفاً به بعض ملاحظات تتعلَّق بعمل جده، ما زال يحتفظ به.


لا يجب أن أتسرع في زيارتي لقارة أم الصغير، فأنا ما زلت في أول أيام الرحلة، بل ما زلت في أولى ساعاتها، ولكن لا يوجد هنا فنادق وكيف سأقضي ليلة في بيت لا أعرفه ولا أعرف عادات أهله بعد؟ طلبت ممن تطوَّع لمرافقتي أن يصحبني إلى العين الحمئة واسمها عين رجوا، الحقيقة أنها حمئة فعلاً. حين اقتربنا منها أشار إلى ما يشبه هرماً أسمنتياً دون أضلاع، تفور منه المياه المسكونة ببخارها الساخن، وتنساب إلى البحيرة أو الأنسب أن أقول إلى حوض التبريد الأول المحيط بالعين، حتى يستطيعوا بعد ذلك توزيعها لري الأراضي المحيطة بعدما أن ترسب معادنها في الحوضين الأول والثاني.

بالطبع لا يوجد أيُّ دليل على أنها هي العين الحمئة المذكورة في القرآن، وإن كانت تناسب قصة الإسكندر ذي القرنين لمروره بهذه المنطقة قبل ألفين وثلاثمائة عام.





